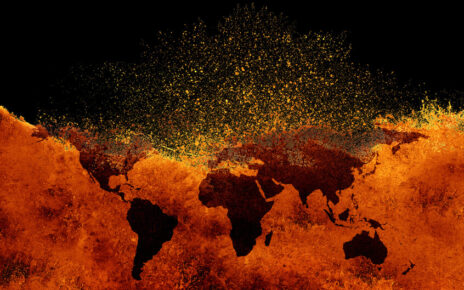الأكيد، إلى الآن، أن «حراك تشرين» سرّع في احتضار العملية السياسية الجارية منذ عام 2003، من دون أن يُقدّم بديلاً منها، في وقت يلوح فيه شبح الفوضى والانفلات الأمني في الأفق. والأكيد أيضاً أن «الحراك» عَجِز عن إنتاج قادة ووجوه، في ما يوصف من قِبَل البعض بأنه مقصود؛ حتى «يظلّ الحراك لقيطاً… لا أب ولا أمّ له، فقط للاستغلال والاستثمار». على أن النقاش يظلّ مفتوحاً حول السياقات؛ يرفض فريق أوّل، هنا، «تشبيك» الأسباب، مكتفياً بالسياق الداخلي الاقتصادي – الاجتماعي للاحتجاجات. في المقابل، يذهب فريق آخر إلى اتّهام التظاهرات بأنها «بيدق» بيد السفارات، وبقيادة «انقلاب ناعم». أمّا الفريق الثالث فيفضّل اتخاذ مسافة من المعسكرين المتقدّمَين، باعتباره أن ثمّة أسباباً طبيعية تدفع الشباب إلى «الثورة» على واقعهم، ولكن في الوقت عينه ثمّة أيضاً من يتحيّن الفرص، وخصوصاً أن الشارع العراقي سهل الاختراق، وهو ما تجمع عليه قيادات أمنية رفيعة.
لا «الحراك» صاغ ورقة إصلاحية، ولا الأحزاب والقوى تَقدّمت بطرحٍ متكامل
في هذا الشقّ تحديداً من النقاش، أي اختراق الشارع من قِبَل أجهزة أمنية خارجية، بات واضحاً، مثلاً، الدور الإماراتي الكبير في «صبّ الزيت على النار». وهو دور استفاد من بطء حكومة عادل عبد المهدي في تنفيذ برنامج إصلاحي، ومن سعي الأحزاب والقوى (على اختلافها) إلى استثمار الأزمة لتحسين مكاسبها، وإظهارها عقلية محكومةً بالأنانية والسطحية. أمّا الدم والنار اللذان صبغا تلك الأيام، فلا يزالان يحتاجان إلى تدقيق وتمحيص، علماً بأنه حتى اللحظة لم يصدر أيّ اتهام صريح لشخص أو جهة.
في التداعيات، لا «الحراك» صاغ ورقة إصلاحية، ولا الأحزاب والقوى تَقدّمت بطرحٍ متكامل، فيما أعلن الكاظمي، قبل أيام، عن «ورقة إصلاحية» لم تُكشَف تفاصيلها إلى الآن. عملياً، المراوحة لا تزال سيّدة المشهد، في ظلّ الاستعدادات لانتخابات تشريعية مبكرة وفق قانون يتيح تمثيل الشرائح المغيّبة. ولكن، يبقى السؤال: ماذا لو أنتجت الانتخابات المرتقبة تركيبة مماثلة للتركيبة الحالية؟
بعد عام على «زلزال تشرين»، ووسط تحذيرات من أن «موجاته الارتداديّة» قد تعود في الأيام القليلة المقبلة، تزدحم الأسئلة، فيما الأجوبة مفقودة. أمّا الطبقة السياسية فالواضح أن لا رغبة لديها في التغيير، وأن كلّ ما تفعله انتظار «تسوية» من الخارج ربّما تنضج قريباً.
«حكومة الثورة»… عاجزة
في السنويّة الأولى لاندلاع الاحتجاجات العراقية، يبدو الوضع في الساحات مختلفاً. مشاهد الدم والقتل والمصادمات مع القوات الأمنية غابت عن الساحات، بعدما شكّلت سبباً رئيساً لإطاحة حكومة عادل عبد المهدي، والتوطئة لصعود حكومة مصطفى الكاظمي. وعلى رغم اعتبار الأخيرة نتاجاً للحراك الشعبي، إلا أن المتظاهرين يرون أنها لم تحقّق إلا أشياء بسيطة من مطالبهم.
وفي هذا الإطار، يلفت الناشط أمير محمد، في حديثه إلى «الأخبار»، إلى أن المحتجّين رفعوا، منذ اليوم الأول، مطالب عدّة، منها «استبدال الحكومة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وتعديل الدستور»، ثمّ أضيفت إليها «ملاحقة قَتَلَة المتظاهرين والفاسدين… لكن هذه المطالب لم يتحقّق منها سوى ما يخدم مصلحة الأحزاب القابضة على السلطة».
وعلى رغم تعهّد الكاظمي بتقديم الجناة إلى القضاء، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة، إلا أن هناك مَن يستبعد ذلك. ويرى مصدر سياسي، في حديث إلى «الأخبار»، أن الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعصف بالعراق تحول دون إجراء انتخابات مبكرة، وخصوصاً في ظلّ استمرار التناحر على ملحق قانون الانتخابات، وعدم التوصّل – حتى الآن – إلى صيغة نهائية للدوائر الانتخابية، ترضي مختلف الأحزاب والقوى.
بناءً على تلك المعطيات، ثمة توقعات بعودة التظاهرات على نحو أكبر وأوسع في الـ 25 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في عدد من المدن الجنوبية. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن التظاهرات الجديدة سترفع شعارات حلّ البرلمان وتعديل الدستور، وربّما الدعوة إلى إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح.
ثمّة توقّعات بتصعيد يقود إلى تظاهرات أكبر وأوسع في الـ 25 من تشرين الأول الجاري
في هذا الوقت، يستمرّ الجدل في شأن ما أفرزته «تظاهرات تشرين»، وخصوصاً لناحية تأثيراتها على الخريطة السياسية، والمعادلة الطائفية – العرقية (الشيعة – السُنّة – الأكراد) التي كرّسها الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003. وفي السياق، يعتقد البعض أن ما تُسمّى «القوى المدنية» استفادت من الحراك، بعدما تَمكّنت على امتداد السنوات الماضية من كسب قطاعات شعبية غير قليلة عبر وسائل متعدّدة، وخصوصاً منها التركيز على فساد الاتجاه الإسلامي في السلطة وفشله. وعلى ضوء ذلك، تتزايد التوقعات بخسارة الإسلاميين مزيداً من رصيدهم الشعبي، واستعار التنافس بينهم وبين المدنيين، وخصوصاً إذا استمرّ المدنيون في التمسّك بالصبغة المدنية (لا العلمانية) للاحتجاجات، في مقابل إصرار الجماعات الإسلامية على تأكيد التوجّه العلماني لخصومها، والذي يُنظر إليه عراقياً بنوع من الارتياب.
على أيّ حال، يبدو أن ما سبق وأعلنته المرجعية الدينية في النجف (آية الله علي السيستاني)، العام الماضي، من أن «ما بعد هذه الاحتجاجات لن يكون كما قبلها… فليتنبّهوا إلى ذلك»، سيظلّ هو الحاكم في المرحلة المقبلة.
ورقة واحترقت…
مع مرور عام على انطلاق الاحتجاجات العراقية، أو كما عُرفت باسم «ثورة تشرين»، لم تفرز الساحات أيّ قيادةٍ ولم تنتج أيّ أدبيات، بل تَلطّى مُحرِّكوها خلف شعارات فضفاضة لا تُفصح عن شيء، مِن مِثل «ثورة قائدها الوعي». وهذا ما دفع بجزء كبير من المثقّفين العراقيين إلى أن يَنزلوا بالسياسة إلى مستوى المطالب الفردية، وحجّتهم في ذلك أن الشعب لا يعي المستويات العليا من الصراع. هذه الحجّة ليست بالثورية أبداً، بل تنبع من خلفيات انتهازية وعاطفية لتقديس مطالب الشعب والانحناء أمامه، في مشهد يشبه مشهد «نضال الخبز والزبدة»، والذي ابتدعه الاقتصاديون الروس، ونقده لينين في كتابه «ما العمل؟».
منذ بداية الاحتجاجات، رُفعت مطالب عدّة: تغيير العملية السياسية الجارية برمّتها، محاسبة الفاسدين، تحسين الواقع المعيشي والخدمي، إيجاد حلّ للبطالة التي تكتسح أوساط الشباب… إلخ. ومع الضخّ الإعلامي الإقليمي والعالمي المكثّف حول الحدث، كانت تظهر المزيد من المطالب، وينفتح الباب على تَخيّلات وردية عمّا سيأتي. تَعزّز هذا الجوّ عندما تَقدّم رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي، بالاستقالة، وبدأت بعده رحلة البحث عَمَّن سيَخلُفه. كانت الساحات تقول كلمتها حيال أيّ مرشح، إلى درجة خُيّل إلى المتواجدين فيها أن صناعة الحدث تبدأ منهم. لكن تَبدّد ذلك كله عندما تَشكّلت الحكومة الجديدة. خبا الصوت تدريجياً، واختفت رمزيات الاحتجاجات وبيانات الساحات، وأدار الإعلام بشقَّيه المذكورين ظهره للحدث. ولدى سؤالك عن سبب الموت المفاجئ، ستجد جواباً واحداً: «لقد بيعت الثورة». ما كان يُفترض أنه احتجاج شعبي للتغيير من الأسفل، اتّضح أنه حركة لقوى سياسية ومنظمات ذات دعم دولي استخدمت «تشرين» كورقة ضغط نحو الانتقال إلى مستوى أعلى في الصراع، وما إن تمّ الأمر لها، حتى أحرقتها. لقد تَبيّن أن حدث تشرين أكبر من صانعه المتخيَّل: «الشعب العراقي» أو «المواطن العراقي» أو سَمِّه ما شئت، والذي يقف وحيداً في الساحات من دون أيّ تأثير يُذكر.
التنقيب عن ما حَقّقته «ثورة تشرين»، من وجهة نظر مؤيّديها، هو أمر غير مجدٍ، لأنها لم تُحقّق شيئاً. هي حَقّقت ما أرادته منها الأطراف الدولية والإقليمية، والتي منعت من خلالها خروج العراق ولو جزئياً من العباءة الأميركية. لكن من يُسمّي نفسه «المتظاهر المستقلّ»، لم تُحقّق له «تشرين»، من برنامجه السياسي المبعثر على منصات الساحات، أيّ شيء. لم يتعدّل الدستور، ولم يتبدّل النظام، ولا انتفى دور الأحزاب، ولم تُتجاوز صيغ المحاصصة الطائفية والحزبية، بصرف النظر – أيضاً – عن أن هذه النقاط لن تُحلّ بالإرادوية، بل هي خارجة أصلاً عن إطار الحلول الإصلاحية الكيانية.
أما الجماهير التي لا تعي المستويات العليا من الصراع السياسي، بحسب المثقف العراقي، وبالتالي خُفّض «النضال» لأجلها، فإن أسئلتها عن منجزات «الثورة» ستكون: كم زاد مدخول الناس؟ كم تَحسّن واقعهم المعيشي والخدمي؟ هل تمّ تجاوز جدول 2*2 الجحيمي للكهرباء؟ هل انتفت البطالة؟ ومرّة أخرى، يجيبنا حدث تشرين بالنفي عن كلّ هذا. الحكومة التي اعتُبرت حكومة «الثورة»، في توصيف نابع من مقدّمات إنشائية أغرقت بها الرأي العام أثناء صعودها، تعيش عجزاً ظاهراً وتطالِب بالصبر، ليعود المتظاهر المستقلّ إلى وضع التململ والضجر، والشعور بأنه تعرّض للخديعة لمرّة جديدة.
ومع كلّ هذا، لن تجد مراجعة واحدة للحدث، لتضعه في سياقه الدقيق، بوصفه لم يكن أكثر من ورقة ضغط دولية ـــ إقليمية لُعبت وحقّقت هدفها واحترقت، ولا مجال لرجعتها مهما تجاوزت الآمال علوّ التراقي.
كلّا، لم تكن مؤامرة…
لا يمكن مقارنة «ثورة تشرين»، التي انطلقت في الـ1 من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، بأيّ ثورة أو حراك شهده العراق الحديث أو الوطن العربي. ولا أبالغ في القول إنها شكّلت نموذجاً عالمياً فريداً، لأنها ببساطة كانت ثورة مختلفة بكلّ المقاييس. عادةً ما يرتبط مصطلح «الثورة» بحقبة الأنظمة الشمولية، لكن «الثورة»»، كمصطلح، يمكن وصفها بـ«الشمولية» فعلاً؛ فهي، في معناها الاصطلاحي، تنطلق من مفهوم التغيير الشامل. بكلّ تميّز وإبداع، استطاع «شباب تشرين» ابتكار نموذج ثوري جديد وفريد، ينطلق من عمق إيمانهم بالديمقراطية، ممزوجاً بفلسفة ثورية نبيلة، ترتكز على مبدأ التضحية الثورية من أجل القيم الديمقراطية.
هذا النموذج الفريد لم يولد محض صدفة، بل هو نتاج طبيعي لتربية وثقافة وإرث حسينيّ، امتزجت به مشاعر الشباب، فأصبح جزءاً من شخصيّاتهم. فقد تربّت هذه الأجيال (من الشباب الشيعي القاطن في وسط البلاد وجنوبها) على قصص وروايات جسّدت تضحيات الحسين وأهل بيته، ليأتي يوم وتستطيع فيه تطبيق نظرية «انتصار الدم على السيف»، بعدما كانت حبيسة الكتب والمجالس الحسينية فقط! كنا نراهم يتسابقون إلى الموت بصدورهم العارية، وهم يحملون رايات وصور الحسين، بل إن تلك المشاهد بدت وكأنها معركة طفٍّ حقيقية، بين خندق الحق الأعزل وبين خندق الباطل المدجّج بالسلاح والموت. هكذا، استطاع «شباب تشرين» أن يجعلوا كلّ العالم يشاهد معركة الطفّ ببثّ مباشر وحيّ.
إن الشبان العراقيين الذين خرجوا العام الماضي كانت أعمارهم في الغالب دون سنّ الـ25، أي إنهم جيل لم يعاصر أيّ حكم دكتاتوري في العراق، ولذلك فهو جيلٌ مختلف عن كلّ مَن سبقه. وهو ما تَجسّد في تبنّي قيم التظاهر السلمي، ورفض دعوات حمل السلاح، فضلاً عن استبعاد أيّ لافتة طائفية أو دينية أو عشائرية، لمصلحة لافتات المواطَنة والحقوق والدستور. كانت ثورة ديمقراطية بامتياز.
في المقابل، كانت الأحزاب والقوى السياسية تحافظ على القيم التقليدية نفسها، رافضة التخلّي عن منظورها المتمحور حول السلطة ومكاسبها. ولذا، فهي اعتقدت أن الثورة ستنتهي بمكاسب سياسية هنا وهناك، واستمرّت في عقد الصفقات وحياكة المؤامرات، واعتمدت على شراء الذمم وقمع الشعب وكيل التهم. كان همّ الطبقة السياسية صياغة الطريقة المثلى للالتفاف على الثورة وسرقة منجزاتها، تارةً عبر القمع، وأخرى من خلال الاتهامات والتخوين، وثالثة عن طريق تصدير أسماء بوصفها «خيارات الثورة». والحقيقة، أن كلّ ما قامت به هو احتيال على الشباب الثائرين لسرقة ثورتهم، وتضييع دمائهم، وركوب موجتهم.
قد يعتقد كثيرون أن «ثورة تشرين» قد انتهت، والحقيقة أنها شكّلت نقطة تحوّل عظيمة، واستطاعت أن تُوجد منظومة قيم جديدة تستحق الفخر والإيمان. إن «ثورة تشرين» لا تزال بذرة تنمو تحت التراب، وستشقّ سطح الأرض قريباً، بساقٍ قوية وأوراق زاهية وزهور جميلة، لتبدأ رحلة ذات أمد طويل من التغيير والنموّ. قيم «تشرين» تشرّبتها نفوس الشباب العراقيين، وكلّ جيل قادم سيكون أقوى «تشرينيّاً» من الجيل الذي قبله، وأكثر قدرةً على الإزاحة والتصدّي.
قيم «تشرين» هي قيم العراق الجديد.